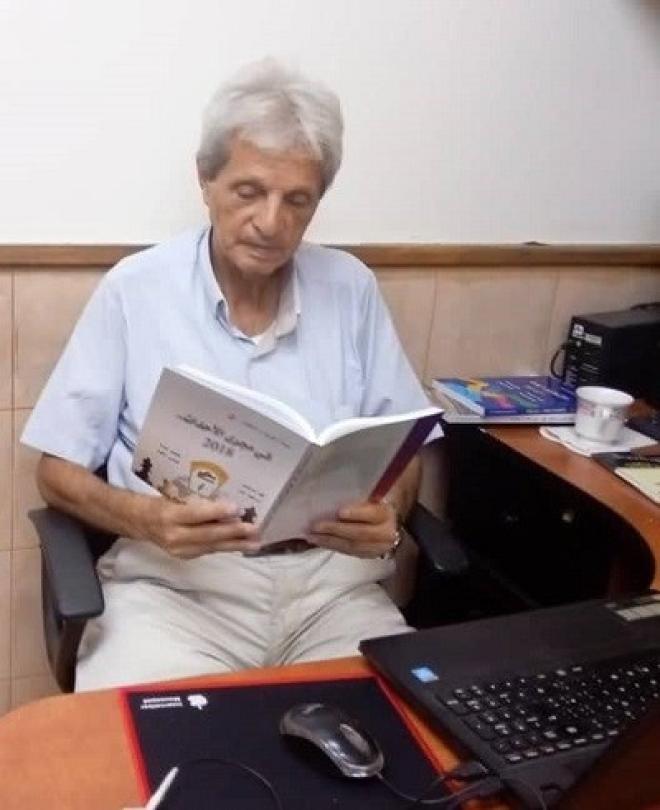- أسامة خليفة
- باحث في المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف»
قراءة في كتاب «في العلمانية والدولة المدنية»، كتاب يحمل الرقم «3» في إطار سلسلة «دليل المعرفة»، التي يصدرها المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف».
في مرحلة ما قبل ظهور ثقل وتأثير الإسلام السياسي في المنطقة العربية، وخلال عقود نضال حركة التحرر الوطني الفلسطينية، كان هاجس المنظمات الفلسطينية هو صوغ مشروع رؤية نضالية تبعد عن الصراع شبهة الصراع الديني، فالصراع مع اسرائيل حُدّد كصراع مع مشروع صهيوني كولونيالي استيطاني إحلالي وليس مع اليهودية كدين أو مع اليهود كأتباع ديانة، ومن هنا شيوع مفهوم « الحل الديمقراطي» للمسألة الوطنية الفلسطينية بإقامة دولة ديمقراطية علمانية في فلسطين تقوم على المساواة في المواطنة بين معتنقي جميع الأديان، جاء هذا في أدبيات عديد من فصائل المقاومة الفلسطينية الرئيسية التي انخرطت كأطراف مشاركة في إعادة تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية بدءاً من العام 1968، واستلام هذه الفصائل رسمياً لقيادتها في العام 1969، ولم يغيّر في جوهر رؤية الصراع من هذا المنظور تبني «م.ت.ف.» للبرنامج المرحلي عام 1974.
بقي الحقل الفلسطيني طوال الفترة الممتدة من ستينات وحتى أواخر الثمانينات القرن الـ20 مقتصراً على الأحزاب والحركات العلمانية، ومنذ اندلاع الانتفاضة الأولى عام 1987، دخلت هذا الحقل حركات إسلامية (حماس والجهاد) أخذت تمثل شيئاً فشيئاً وزناً متنامياً وصاعداً في الخارطة السياسية الفلسطينية، وهو ما انعكس على المشروع والرؤية الفلسطينية السابقة للصراع العربي- الإسرائيلي حتى وصل إلى تصوره أحياناً، كصراع ديني، وبحسب أحد زعماء حماس: فإن فلسطين هي مركز الصراع العقائدي والحضاري بين الصهيونية مدعومة من قبل القوى الصليبية الامبريالية الطامعة المتعصبة في حلف الشيطان، مقابل حلف أولياء الله، وحسب أحد زعماء الجهاد الإسلامي: اعتبر أن الحركة الإسلامية الجهادية ليست محكومة في صراعها بمصالح اجتماعية أو وطنية أو مزاج إقليمي وإنما محكومة بأسباب قرآنية تاريخية واقعية أوسع من أي حدود جغرافية.
يرى بعض الباحثين أن رؤية الإسلام السياسي لطبيعة الصراع وأهدافه لم تأتِ من فراغ، بل هي في الأصل موجودة في الأدب السياسي لحركة الإخوان المسلمين وحزب التحرير الإسلامي في فلسطين منذ الأربعينات من القرن الماضي، لكن الجديد فيه هو درجة تأثيرها الكبيرة في الثقافة السياسية الفلسطينية المعاصرة التي انشطرت إلى ثقافتين، الأولى: تنطلق من الطابع الوطني التحرري( ومضمونه قومي، تقدمي، علماني، معادٍ للامبريالية والاستعمار والعنصرية)، والثانية: ذات عقيدة دينية سياسية تديّن الصراع والسياسة، مع عدم تجاهلها لمكوناته الوطنية والقومية وأبعاده التحررية، لكن على قاعدة أن محور الصراع هو ديني.
إن طبيعة الدولة مدنية أم دينية مطروحة بقوة على جدول أعمال المجتمعات العربية وقواها السياسية، فقوى تدفع باتجاه الدولة الدينية، واتجاهات أخرى تتبنى مقولة الدولة المدنية المطعمة دينياً، وثمة قوى تناضل من أجل الدفاع عن الدولة المدنية وتطوير صيغتها حيث هي قائمة، أو إرساء أسسها حيث ما يزال الصراع يدور حولها.
وفي الحالة الفلسطينية وهي تواجه مشروع صهيوني يقوم بجوهره على الانغلاق والتعصب والعنصرية استناداً إلى الأساطير الدينية المؤسسة له، فالفلسطينيون بأمس الحاجة إلى تعميق مفاهيم الانفتاح والتسامح والثقافة الديمقراطية، لذلك نجد أن البرامج لعدد من القوائم الانتخابية الفلسطينية شددت على الانفتاح والتسامح ومواكبة التطور العلمي العالمي، واستيعاب أوجه التقدم الحضاري، والدمج بين أبعاد الثقافة الوطنية والقومية والإنسانية والدفاع عن الثقافة الديمقراطية في وجه العنصرية والتطرف السياسي والديني.
بينما طالبت قوى إسلامية في برنامجها الانتخابي بـالتوقف عن استيراد القوانين ومراعاة الخصوصية الاسلامية للمجتمع الفلسطيني، بالتشديد على دور الشريعة فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية والمحاكم الشرعية، والتشريع بصفة عامة، وصولاً إلى دورها في السياسة التربوية والتعليمية، من منطلق أن الإسلام نظام شامل لكل حركة الحياة، وهذا يعكس المنحى المتشدد في التعاطي مع قضايا التشريع على خلفية الطموح لـ«أسلمة القوانين».
أن التعددية القائمة في المجتمع الفلسطيني، وضرورات الوحدة الوطنية الناجمة عن مرحلة التحرر الوطني، ولاحقاً بناء دولة الاستقلال الوطني الناجز، الدولة السيدة الحرة، تحتم على الشعب الفلسطيني في مرحلتي التحرر الوطني وبناء الدولة سواء بسواء، اعتماد قاعدة لا تنفصم عراها تجمع بين الديمقراطية والتعددية والعلمانية باعتبارها تعبيرات متكاملة لمبدأ واحد هو الديمقراطية، بمضمون التعددية وفي إطار العلمانية لتبقى «م.ت.ف.» ولاحقاً الدولة الفلسطينية دولة تقوم على المواطنة في إطار المساواة والحرية، دولة لجميع مواطنيها.
اعتبرت حماس مثل معظم الحركات الإسلامية في الوطن العربي، بأن الإسلام يمثل ديناً ودولة، والشريعة الإسلامية ستكون في نظرها محور النظام السياسي المستقبلي في فلسطين، ومرجعية الحكم، ومصدر التشريعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما اعتبرت أرض فلسطين وقفاً اسلامياً، وملكاً لكل الأجيال، ولا يحق لأي زعيم أو طرف التنازل عن أي جزء منها.
شهد الفكر السياسي لحركة حماس تطوراً ملموساً عبرت عنه «وثيقة المبادئ والسياسات العامة» الصادرة عن حركة حماس في نيسان/ابريل عام 2017، بخلاف ما كان يركز عليه ميثاق حماس عام 1988 من أن الحركة جناح الإخوان المسلين في فلسطين، تقترب حماس في الوثيقة الجديدة من مواقع ومنهجية حركة التحرر الوطني الفلسطينية، وإن بمرجعية دينية، مع أخذها لمسافة معينة من الفكر الإسلامي السياسي الأصولي «الأممي» العابر للحدود الوطنية، وهو الفكر الذي تعتمده حركة الإخوان المسلمين التي تتحدر حركة حماس من صلبها،
وأكدت حماس في الوثيقة المذكورة: «أنَّ الصراع مع المشروع الصهيوني ليس صراعاً مع اليهود بسبب ديانتهم؛ وحماس لا تخوض صراعاً ضد اليهود لكونهم يهوداً، وإنَّما تخوض صراعاً ضد الصهاينة المحتلين المعتدين، بينما قادة الاحتلال هم من يقومون باستخدام شعارات اليهود واليهودية في الصراع، ووصف كيانهم الغاصب بها»
وجاء أيضاً في الوثيقة المذكورة أن « حماس ترفض اضطهاد أيّ إنسان أو الانتقاص من حقوقه على أساس قومي أو ديني أو طائفي، وترى أنَّ المشكلة اليهودية والعداء للسامية واضطهاد اليهود ظواهر ارتبطت أساساً بالتاريخ الأوروبي، وليس بتاريخ العرب والمسلمين ولا مواريثهم. وأنَّ الحركة الصهيونية – التي تمكّنت من احتلال فلسطين برعاية القوى الغربية- هي النموذج الأخطر للاحتلال الاستيطاني، الذي زال عن معظم أرجاء العالم، والذي يجب أن يزول عن فلسطين».
وتتمايز حماس عن الحركات الإسلامية الأخرى في عدد من الخصائص والاستجابات التي فرضها الواقع والسياق الفلسطيني الخاص، وفرض عليها تبني رؤى وسياسات مختلفة، بخصوص فكرة الحدود القومية والوطنية حيث تنوعت مقاربات تيارات الإسلام السياسي بين الرفض التام للحدود القومية وعدم الاعتراف بها، إلى القبول الخجول وصولاً للإقرار فيها بحكم الأمر الواقع، فإن حماس تطورت بشكل متسارع وحاولت إعادة تعريف نفسها من حركة إسلامية دينية ذات بعد وطني تحرري إلى حركة تحررية وطنية بمرجعية دينية، دون الإشارة إلى أي انتماء ما بعد «حدودي»، وبإعلاء البعد الوطني على حساب الديني، من خلال التأكيد على «الجغرافية الفلسطينية» على حساب « التاريخية الدينية الفلسطينية» ومن خلال التأكيد المتجدد على تحديد نشاط وأهداف وغايات حماس ضمن هذه «الجغرافية الوطنية» فقط، فعامل المشروع الصهيوني الاحتلالي القائم على جغرافية فلسطين، وأرادها «وطناً قومياً لليهود»، سرّع من انتقال حماس من عموميات "لا حدود الدين" إلى "خصوصيات الوطن"، .
وعلى الرغم من أهمية النصوص التي أصدرتها حماس، وأهمها «وثيقة المبادئ والسياسات العامة» للعام 2017، يبقى الاختبار الحقيقي هو ترجمة هذه النصوص على الأرض، خاصة لجهة «فلسطنة» حماس تماماً وتقديمها الوطني المحدد على الديني المعمم وتجسده في العلاقات الوطنية البينية.
جاء في مشروع مسودة الدستور الثالثة في الباب الأول، الأسس العامة للدولة مادة (1): فلسطين دولة مستقلة ذات سيادة نظامها جمهوري وإقليمها وحدة لا تتجزأ بحدودها عشية الرابع من حزيران/يونيو 1967، في مثل هذه الحالة، وحين يعرض مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي، هل فلسطينيو الشتات معنيون بالاستفتاء؟. وعلى الأقل ما الذي يشدهم إلى نقاش دستور دولة فلسطين؟. المادة (13) ربما تضمن لهم حقوق المواطنة، لكن بشكل ملتبس مع المادة (1) فيما يخص اللاجئين الفلسطينيين: «للفلسطيني الذي هُجّر من فلسطين ونزح عنها نتيجة لحرب عام 1948 ومنع من العودة إليها حق العودة إلى الدولة الفلسطينية وحمل جنسيتها وهو حق دائم لا يسقط بالتقادم».
وفق هذا السياق جرى استطلاع للوقوف على الرأي العام في الضفة والقطاع وليس في عموم مناطق التواجد الفلسطيني، حول ستة عناوين:1- مبادئ الشريعة كمصدر للتشريع.2- الدولة الدينية.3- فصل الدين عن المؤسسة السياسية . 4- شعار الدين لله والوطن للجميع. 5- المساواة بين المسلمين والمسيحيين.6- المساواة بين المرأة والرجل.
جاءت نتائج الاستطلاع متناقضة، ليس فقط بسبب تداخل عناوين الاستطلاع هذه وتشابكها، بل أيضاً ثمة نقص في المعرفة يجعل أفراد العينة لا يرون تعارضاً بين دولة دينية وعدم فصل الدين عن المؤسسة السياسية، إذ تفيد نتائج الاستطلاع أن الأكثرية 56% مع دولة دينية، في حين أن الأكثرية 88% تؤيد شعار الدين لله والوطن للجميع ، الدولة للجميع تعنى أن الدولة تتعالى فوق الهويات الجزئية، دينية كانت أم قومية إثنية، فالدين متحيز لجمهور المؤمنين، والإثنية متحيزة لقاعدتها، أما الدولة فيجب أن تكون لجميع مواطنيها، في مجتمع يعرف قيمة الإنسان، ويحترم حقوقه ويقدس حرياته، وتصبح الدولة المدنية الديمقراطية التعددية ضرورة موضوعية من أجل ملاقاة متطلبات الدولة العصرية الدولة الحديثة، وحدتها وتماسكها تستمدها من وحدة وتماسك مجتمعها، إنها الدولة الحديثة بأهم مبادئها: فصل السلطات، وضبط المسؤوليات، ونشوء بنية مؤسسية تعزل السلطة عن العلاقات الشخصية، و الفصل بين الدين والسياسة، ولا يعني هذا فصل الدين عن المجتمع، ولا يعني معارضة وجود أحزاب دينية من حيث المبدأ، فثمة الكثير من الأحزاب ذات المرجعية الدينية في بلدان مسلمة مثل تركيا ( حزب العدالة والتنمية)، ولكن هذه الأحزاب جميعها تشكل جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع المدني والسياسي العلماني في بلدانها، ولا تطرح العودة بمجتمعاتها إلى نسق الدولة الدينية.
وفي نهاية المطاف فإن فلسطين الدولة الوطنية الحديثة لا تتطلب إلا إجماعاً عاماً على قيم عليا مشتركة تتصل بوحدة البلاد والانتماء لها، ووحدة مؤسساتها، واحتكار السيادة في مجالها الإقليمي والتمثيل الدولي، فلسطين الدولة العلمانية هي دولة كل المواطنين بصرف النظر عن جنسهم أو لونهم أو عقيدتهم، تقوم على المواطنة، والتعامل المتساوي بين جميع المواطنين لا تمييز بينهم، لا تقصي ولا تستبعد أو تهمش أي طرف من الأطراف الاجتماعية، دولة قائمة على التعددية والتداول السلمي للسلطة، ووجود ثقافة ديمقراطية وفكر سياسي حر ومرن، وتعدد لمنابر التعبير الطليق والصحافة الحرة، ووجود الأحزاب السياسية وحرية المرأة ومساواتها.
تاريخياً اتصف المجتمع الفلسطيني بالتعددية الدينية والطائفية إلى أن برز المشروع الصهيوني الاستعماري، الذي عمل على جلب المهاجرين اليهود إلى فلسطين، وأدى إلى تغيير ديمغرافي، وفرز ديني، وتطرف جهات يهودية، وعنصرية ضد من ليس يهودياً، أمكن أن يكون الرد عليها تطرف في الأديان الأخرى، فليس التطرف سمة للدين الإسلامي فقط كما تصوره دول الغرب الامبريالية في ترويجهم للعولمة وصراع الحضارات.
وإذا كان برنامجنا الاستراتيجي هو إقامة دولة ديمقراطية موحدة في فلسطين «الانتدابية» أي من النهر إلى البحر ومن رفح إلى الناقورة، فإن الإصلاح الديني يشكل مدخلاً رئيسياً للإصلاح السياسي الشامل ويساهم في الحد من نشر فكر التخوين والتكفير، والشيء الأهم أنه ينقل الفكر الديني من الجمود إلى رحاب التجديد والتنوير.
يقوم الإصلاح على مسألة رئيسية، فصل الدين عن الدولة، ويهدف إلى إعادة الدين إلى موقعه الحقيقي بوصفه الحامل للقيم الإنسانية والأخلاقية والروحية، وتخليصه مما يصيب الدين من سلبيات عندما يتحول عن مهمته الأصيلة إلى لاعب في السياسة، مما يحور دوره من هداية البشر إلى عامل في تفجير الحروب المذهبية بينهم.
فيما يخص نص الفقه الإسلامي المطلوب تنقيحه وتطويره ليتوافق مع مقتضيات العصر وحاجات التطور الاجتماعي، حيث لازالت آراء الفقهاء القدامى المرجع الأهم الذي يستند إليه رجال الدين في إبداء آرائهم وتفسيرهم الديني، وتحول الفقه الإسلامي على امتداد القرون الوسطى إلى «مقدس» أسوة بالنصين التأسيسيين في الإسلام (القرآن الكريم والحديث الشريف) وبات نقد فتوى أحد رجال الدين مساً بالمقدسات نفسها، و مسألة فوضى الفتاوى الصادرة في كل مكان وعلى لسان أي رجل دين تطرح قضية الإصلاح الديني من داخل المؤسسة الدينية كشرط أساسي للانطلاق بهذا الإصلاح ونجاحه، أي يحتاج الإصلاح إلى توفر مصلحين من رجال دين، في القرنين الـ19 والـ20، انطلقت محاولات في الساحة العربية، في مصر تحديداً، لم يكتب لها النجاح، لأسباب عديدة، أهمها عدم توفر القوى الاجتماعية الحاملة لها والمدافعة عنها، على غرار ما شهدته حركة الاصلاح الديني في أوروبا.
المد الإسلامي في المنطقة العربية، والمناخ الثقافي والسياسي الذي ساد بصعود أحزاب وتيارات الإسلام السياسي بدأ ينعكس على بنود ومكونات الوثائق النظرية والدستورية المؤسسة للاجتماع السياسي الفلسطيني، ومن يدقق في الوثائق السياسية والدستورية الفلسطينية سيلاحظ مثلاً أن «القانون الأساسي» للسلطة الوطنية، الذي أقر عام 2002 تطرق إلى موقعية الدين بشكل غير مسبوق يقطع مع الرؤية التي حملها «الميثاق الوطني» أو «إعلان الاستقلال» وقد نصت الفقرة (1) من المادة الرابعة على أن «الإسلام هو الدين الرسمي في فلسطين ولسائر الديانات السماوية احترامها وقدسيتها»، وفي الفقرة (2) على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع»، وطالبت حركة حماس ببرنامجها الانتخابي للمجلس التشريعي عام 2006 بأكثر من ذلك بـ« جعل الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع في فلسطين» .
وكذلك الأمر في «مشروع الدستور الفلسطيني»، الذي كانت إحدى مسوداته التي نوقشت عام 2003 تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولأتباع الرسالات السماوية تنظيم أحوالهم الشخصية وشؤونهم المدنية وفقاً لشرائعهم ومللهم الدينية..» وإن كان التمييز بين الشريعة ومبادئ الشريعة التي اعتمدها مشروع الدستور الفلسطيني، مقبول نظرياً، إنما التباين في الرؤية بين المشرعين احتمال مفتوح على مصراعيه، ذلك أن الاجتهاد في مثل هذه المسائل ليس خاص بعلماء الدين بمعزل عن أي سياق سياسي ومجتمعي ملموس، بل هو مسألة سياسية بامتياز تقع في قلب المنظومة التبريرية للنظام السياسي أو أي برنامج أو توجه سياسي، هذا لا يعني أن لا اجتهاد في الدستور، لكن ثمة فارق كبير بين اجتهاد في نطاق نص الدستور ومواده، وآخر في نطاق مرجعية أعلى يحيل إليها الدستور، فقيمة أي دستور تكمن في أن تشكل نصوصه مرجعية عليا للقضايا لتي تطرح نفسها في مجرى الحياة لا أن تحيل نفسها إلى مرجعية أخرى.
مازال النقاش على مشروع الدستور الفلسطيني يدور غالباً في الطوابق العليا ومازال حكراً على نخب وفئات محدودة من المهتمين ولم تنتقل بعد إلى الدائرة الأوسع التي تسمح بإشراك فئات عريضة من نشطاء الحركة الفلسطينية من أبناء الشعب في الوطن وإلى حد ما في الشتات، وما يكسب النقاش أهمية وقيمة عملية أن اللجنة الخاصة بإعداد الدستور أكدت على المساهمة في تحسين صياغة مسودة الدستور سواء باقتراحات التعديلات أو الحذف أو الإضافة، هذا فيما يتعلق بمشروع مسودة الدستور المنقحة والتي تتضمن جميع التعديلات حتى تاريخ 4/5/2003.
إن مشروع الدستور الفلسطيني مازال مطروحاً للنقاش، وسيبقى مطروحاً للنقاش، حتى بعد اعتماده، ولاسيما فيما يخص علاقة التشريع بالشريعة، وكان بالإمكان أن لا تتحول هذه العلاقة إلى نص دستوري، وتجنب ما ينجم عنها من مشكلات ومعضلات سياسية واجتماعية واقتصادية، وتخفيف إحكام قبضة الأصولية على مناحي معينة ومؤثرة من الاجتماع السياسي و المدني والديني، تنتصب عائقاً حقيقياً أمام التطويرات المطلوب إحداثها على البنى التشريعية، وفي هذا لن يكون الدستور الفلسطيني سباقاً أو مبادراً، فتسعة دساتير عربية أنجزت قبل عقود ما هو مطروح على الأجندة الفلسطينية، عندما لم تقم دساتيرها – بالنص المباشر – علاقة بين التشريع والشريعة.
إن إرث الحركة الوطنية الفلسطينية هو إرث سياسي وطني علماني منذ انطلاقتها في مطلع العشرينيات من القرن العشرين، قبل وبعد زعامة الحاج أمين الحسيني وانتهاء بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية لهذه الحركة مروراً بمختلف مراحلها النضالية، وتعدد منعطفاتها ومحطاتها السياسية، ومن أبرزها الدورة الـ19 للمجلس الوطني الفلسطيني 15/11/1988 التي صادقت على «إعلان الاستقلال الفلسطيني» وهو الوثيقة الأساس والمرجعية التي لا نقاش لموقعها الحاسم فيما يتعلق بالكيان الوطني الفلسطيني، ومما ورد فيها: إن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا، فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، وتصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الإنسانية، في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين الأحزاب ورعاية الأغلبية حقوق الأقلية واحترام الأقلية قرارات الأغلبية، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل، في ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء المستقل وعلى أساس الوفاء الكامل لتراث فلسطين الروحي والحضاري في التسامح والتعايش السمح بين الأديان عبر القرون.
في أدبياتها تدعو الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى أن تكون دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، دولة مدنية ديمقراطية، هذا ما أتى على ذكره بوضوح البرنامج السياسي للجبهة الديمقراطية ونظامها الداخلي في أكثر من موقع وبالتحديد في سياق إبراز نضال الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من أجل:
- الاستقلال الوطني وبناء نظام سياسي ديمقراطي يحترم التعددية السياسية والحزبية والحريات العامة وحقوق المواطنين، وصولاً إلى دولة ديمقراطية تقوم على مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين وبين المرأة والرجل. قد يعتقد البعض أن مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في كافة المجالات سيصطدم في مكان ما بالنص الشرعي، وعلى افتراض ذلك، فإن المرجعيات المختصة قادرة على إيجاد المخارج واجتراح الحلول التي تنتج بنية قانونية ملبية لمتطلبات المجتمعات العصرية الحديثة انطلاقاً من مواءمة النص الشرعي مع غاياته ومقاصده التي تخدم تطور المجتمع القائم على ركيزتي الحرية والمساواة.
- ومن أجل التحرر الوطني والعدالة الاجتماعية والمساواة في المواطنة في إطار الدولة الديمقراطية المدنية...
إن التوقف أمام الدولة المدنية لاستئناف الحوار حولها في الحالة الفلسطينية، يكتسي أهمية أيضاً من زاوية الدراسة المعمقة لنتائج أعمال «لجنة صياغة دستور فلسطين» التي أنجزت أعمالها بعرض «فلسفة ومرتكزات عمل اللجنة» و«مسودة الدستور» للنقاش في الدائرة الضيقة المختصة في أيلول/سبتمبر 2015، قبل أن تعود للالتئام مرة أخرى للبحث في الملاحظات والتدقيقات التي سترفع إليها.
وفي هذا السياق يسترعي الانتباه أسلوب صياغة ما يتصل بـ«المساواة» في فلسفة ومرتكزات عمل لجنة صياغة الدستور التي تجنبت استخدام صيغة «المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين، والمساواة بين الرجل والمرأة» في فقرتين، ذات صلة بالموضوع لصالح اعتماد صيغة «عدم التمييز» أو فكرة «الشراكة التامة» التي لا تضاهي من حيث الوضوح القطعي ولا تصل إلى مستوى صيغة «المساواة» المحصنة إزاء أي تأويل أو اجتهاد آخر ينتقص من مضمون المساواة أو يضعفه، وهاتان النقطتان هما:
- الانطلاق من مفهوم المواطنة في العلاقة بين الفلسطينيين والدولة، بحيث تم استبعاد وتجنب الأمور التي تقلل من قيمة هذه المواطنة أو تؤدي إلى خلق نوع من التمييز والتفرقة ما بين الفلسطينيين، وذلك إلى جانب التأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني وحق اللاجئين الفلسطينيين في الحصول على كافة حقوقهم الفردية والجماعية وفي مقدمتها حقهم في العودة إلى الديار الأصلية وأساسها القرار 194.
- اعتماد فكر وفلسفة الشراكة التامة بين الرجل والمرأة لقناعتنا أنهما شركاء على قدم المساواة في النضال وشركاء في البناء وشركاء في صنع القرار، وكذلك عدم التمييز بناء على النوع الاجتماعي.
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت