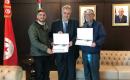لنكن واضحين من البداية. ما من طرف فلسطيني، ونقصد تحديداً حركتي "فتح" و "حماس"، معنيٌّ حقيقة بإنهاء الانقسام الوطني ما لم تُحسم النتيجة مسبقاً لمصلحته. وها هو عقدٌ من الزمن يمر من دون بادرة أمل بانفراجة تلوح في الأفق، بل أصبحت المصالحة أبعد مما كانت عليه قبل عشر سنوات.
ما الانقسام والحالة هذه سوى محاولة لإلغاء الآخر وكيْل الاتهامات إليه في مقابل تضخيم الإنجازات الذاتية، ولنأخذْ القاموس الوطني الفلسطيني مثالاً، فلقد هيمنت عليه لغة خاصة بالانقسام، من مفردات التخوين وأخواته، إلى شعارات أُفرغت من معناها، مثل "وطن للجميع"، و "شراكة سياسية حقيقية"، و "تحكيم الديموقراطية"، و "جمع الشمل". ربما لو كانت العبارات أقل طموحاً في الوضع الحالي، لكانت التوقعات أكثر واقعية.
تُذكِّر الحركتان، إذ تتمسكان بأحقيتهما بالحكم، بالأحزاب التي ما أن تصل إلى السلطة حتى ترفض تداولها، بل إن وضع الحركتين أكثر مأسوية، فهما تتنازعان الحكم تحت سقف الاحتلال الإسرائيلي، وكل منهما في مأزق، فواحدة محاصرة باسم المقاومة، والثانية باسم عملية السلام، وكلتاهما محكومتان بأجندات إقليمية ودولية ومرتهنتان لها.
وللارتهان لهذه الأجندات أثمان، كما أن الانقسام يولِّد التنازلات، فـ "حماس" التي غادرت سورية قبل سنوات ارتضت أن تقيم في حضن قطر، التي لا تخفي علاقاتها مع إسرائيل. ولتحصيل قبول دولي، أصدرت الحركة وثيقة سياسية تضمنت تنازلات قياساً بخطها السياسي، وقبل فترة قصيرة غادر بعض قادتها قطر وتركيا، لتتوصل سريعاً إلى تفاهمات مع مصر على رغم الخلاف الكبير القائم بينهما بسبب العلاقة مع جماعة "الإخوان". وأخيراً، تُظهر الحركة ميلاً نحو إيران على رغم تمنُّع سابق وتدهور في العلاقات. في كل نقلة قدمت "حماس" تنازلات، فلماذا تستطيع التفاهم مع كل هذه الدول ولا تستطيعه مع "فتح" من أجل إنجاز المصالحة؟
والحال ذاتها مع "فتح"، التي تشكل العمود الفقري للسلطة، فلماذا تستطيع التفاهم مع الولايات المتحدة ومع المجتمع الدولي وحتى مع إسرائيل، على رغم كل الشروط التعجيزية والتنازلات التي قدمتها في إطار عملية السلام، ولا تستطيع ذلك مع "حماس"؟
لا شك في أن أسباب تأبيد الانقسام قائمة. تستطيع "حماس" أن تقول إنها تحمي سلاح المقاومة من التنسيق الأمني للسلطة مع إسرائيل، وإنها تدافع عن المشروع الوطني من وطأة عملية السلام. في المقابل، بإمكان "فتح" أن تقول إن وجود "حماس" في السلطة لا يعطل عملية السلام فحسب، بل أيضاً المساعدات والمنح الدولية التي تغطي مصاريف السلطة، على اعتبار أن المجتمع الدولي ما زال يشترط للتعامل مع الحركة والاعتراف بها وبشراكتها في السلطة، قبولها شروط اللجنة الرباعية الدولية الخاصة بالاعتراف بإسرائيل، وبالاتفاقات الموقعة معها، ونبذ العنف، فكيف إن كانت دولٌ تعتبر "حماس" إرهابية؟
حتى إسرائيل لم تعد تخفي اهتمامها ببقاء الانقسام، باعتباره مصلحة استراتيجية أمنية وسياسية، وهو كذلك، إن لم يكن من باب سياسة "فرق تسد" فمن باب استخدامه ذريعة ضد أي عملية سلام مستقبلية، بحجة أن السلطة لا تمثل الكل الفلسطيني، وأن أي اتفاق سلام سيكون جزئياً وليس أساساً لاتفاق دائم.
حتى لو وضعنا إسرائيل جانباً، فأي فرصة للمسيرة السلمية في ظل إقصاء "حماس"؟ وبماذا ستصُد السلطة الفلسطينية الضغوط الأميركية والإسرائيلية في أي مفاوضات إن لم يكن من خلال معارضة قوية، أو على الأقل للمناورة السياسية؟ حتى الاحتكام إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية قد لا يكون مخرجاً أو حلاً حقيقياً، فأي ضمانة لاحترام النتائج فلسطينياً، ثم من يضمن قبولاً إسرائيلياً ودولياً بهذه النتائج إن فازت "حماس"؟
ولأن لا عملية سلام جدية من دون مصالحة، ولأن "حماس" جزء من النسيج الفلسطيني ولا يمكن رميها في البحر، ولأنه ستكون هناك دائماً دول مستعدة لاحتضان الحركة، ولأن ما من وطنيٍ يمكن أن يقبل بالمطروح من أفكار تأبيد الانقسام، مثل انفصال قطاع غزة أو إقامة فيديرالية بينه وبين الضفة الغربية... لهذا كله، سيبقى إنهاء الانقسام أولوية على الأجندة الفلسطينية.
على الأقل، رِفقاً بقطاع غزة وبأهله، فهم الذين يدفعون ثمن الانقسام. من يرضى بأن يكون سبباً في موت ولو شخص واحد بسبب الحصار وإغلاق المنافذ، أو عدم توافر العلاج، أو تلوث المياه، أو حريق في بيت سببته شمعة نتيجة انقطاع الكهرباء لعدم توافر الوقود في إطار المناكفات، أو الجوع والفقر، أو حتى الصواريخ والقذائف المحرمة دولياً في حرب جديدة... أو قهراً؟
كفى. فباستمرار الانقسام، ما من طرف فلسطيني يمكنه الادعاء أنه وطني أكثر من الآخر، بل الكل خاسر، وإن كان الخاسر الأكبر هو الوطن والقضية.
فاتنة الدجاني