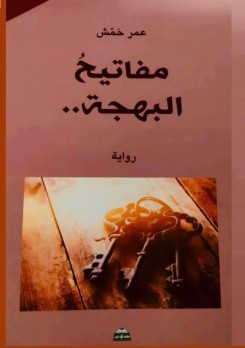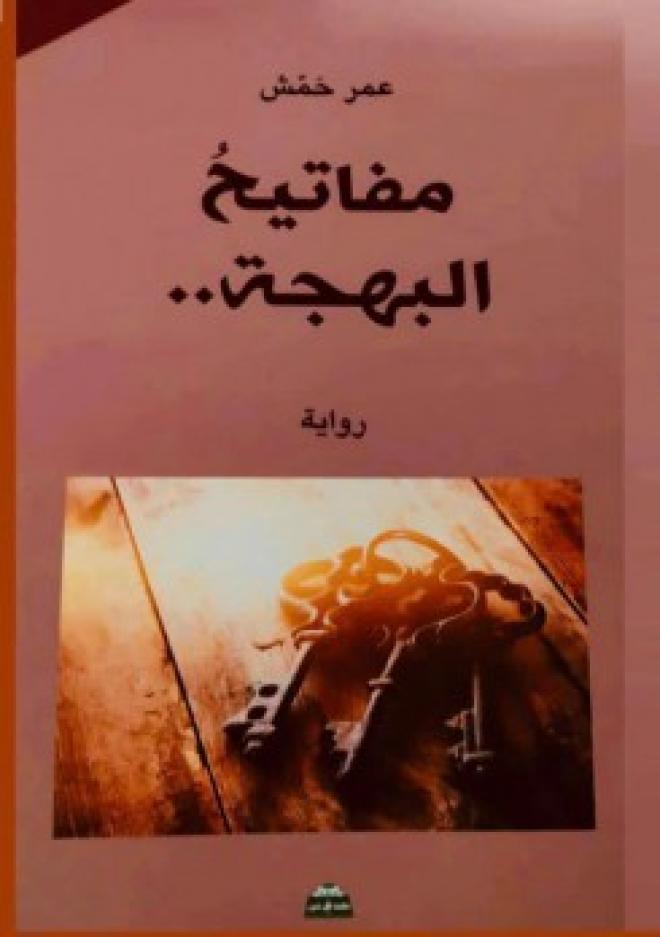ناقشت ندوة اليوم السابع الثقافية المقدسيّة رواية"مفاتيح البهجة" للأديب عمر حمش، تقع الرواية الصادرة عام 2022 عن مكتبة كل شيء في حيفا في 114 صفحة من الحجم المتوسّط.
افتتحت الأمسية مديرة الندوة ديمة جمعة السمان فقالت:
ما أصدق الوصف عندما يأتي على لسان طفل عاش حياة مخيمات اللجوء، يتحدث بلسان بريء ينقل الواقع مجردا كما شاهده دون مؤثرات، ودون أهداف.. بل ودون إدراك لما يحدث، وبعدها يأتي التحليل بلسان الواعي البالغ، الذي يعكس شعور صدمة الهزيمة، هزيمة النكبة ثمّ صدمة النكسة التي عكست واقع النظام العربي الهزيل، وولّدت خيبة أمل، جعل أمّ الرّاوي تدفع بالترانزستور إلى المزبلة، فقد بثّ كمّا هائلا من الأكاذيب، مما زاد حجم وقع الصدمة على كلّ من استمع إلى مذيعي صوت العرب.
رواية مفاتيح البهجة بطلها مخيم اللجوء، وكل من عاش فيه قسرا، فلم يكن من سكّانه من اختار هذه الحياة القاسية، التي حولتهم إلى أرقام، يعتاشون على خيرات وكالة الغوث، ويتعلمون في مدارسها، ويتداوون في عياداتها.
سكان المخيم الذين انتقلوا قسرا من حياة العزّ إلى حياة الذّلّ والمهانة، يتمسكون بمفتاح العودة وأوراق الطابو، يحلمون بالعودة، فقد سلبهم الاحتلال منازلهم وأراضيهم، وجميع ممتلكاتهم، ولكنه لم يستطع أن يسلبهم أحلامهم التي تبث في أرواحهم بعض الأمل، تعينهم على الاستمرار في الحياة، علّهم يسترجعون بعضا من حقوق إنسانيتهم المهدورة.
"مفاتيح البهجة" سيرة ومسيرة شعب، تعرّض للتنكيل والمجازر، جسدها الكاتب في شخصيات متنوعة عكست مكونات المجتمع وأطيافه.
وعلى الرغم من حجم الألم الذي قرأناه في الرواية، كنت أرى الأمل يطل من بين الكلمات، يبشّر بفرج قريب.
" مفاتيح البهجة" سيرة شعب مقهور، ظهرت على صورة سيرة ذاتيّة للكاتب، كتبت بلغة جميلة شيّقة، جرت أحداثها قبل نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948م. إلى ما بعد نكسة 1967م.
لجأ الكاتب إلى أسلوب الاسترجاع، من خلال شهادات حيّة للآباء والأجداد، وصفت تفاصيل مريرة لم يذكرها التاريخ، فوثقها الكاتب كي لا ننسى.
رواية إنسانيّة بامتياز، تعتبر إضافة نوعيّة للمكتبة العربية.
وقالت هدى عثمان أبو غوش:
يؤكد الأديب عمر حمش في هذه الرواية على حفظ ذاكرة الوطن واللجوء شفهيا من جيل لآخرمن خلال سيرة الطفل الذي لم يحمل اسما معينا، هذا الطفل الفلسطيني الذي يمثل الصمود والأمل في رفضه لواقع الاحتلال، وحفظه لذاكرة الآباء، فالطفل في هذه الرّواية يصرّ على نبش الذاكرة، ولا يملّ من استرجاعها، وفي ذلك يؤكد على حقه بمفاتيح البهجة وعدم الاستسلام، ويسترجع الطفل من مخيم اللاجئين أرشيف ما قبل النكبة في مجدل عسقلان وما بعدها" أمي حدّثيني عن مواسمنا في مجدل عسقلان.
-إييه...
- وتشهق، ثم تزفر، وتنتفض كفها؛ لأسكت، لكني وأنا الحافظ دوما أعود..أستذكر الذي كان".
ولذلك نجد الأديب دائم التنقل في وصفه ما بين مجدل عسقلان والمخيم في غزّة. وصف دقيق تصويري لطقوس المدينة ما قبل النكبة، من مواسم نيسان المميزة التي تبهج الكبير قبل الصغير، وما بين سرد الأم وابنها لحكاية الوطن قبل اللجوء، تفوح رائحة عسقلان وتلالها، ووصف حالة المواطن الفلسطيني اللاجىء بعد النكبة في المخيم في غزة، ووصف مشاهد الحرب القاسية الانتظار الوعود الصبر، وفي وصف ذاكرة الحرب من خلال حكاية الوالد والأم والجدة والطفل الذي يحفظ الذاكرة، نجد في وصف الأديب حمش لدقة الوصف ما بين الأماكن تعبيرا عن حالة القهر والمعاناة التي يعانيها الفلسطيني، وعن صرخات المخيمات وإعلان مفاتيحهم التي تبهجهم في سبيل حق عودتهم، فمفاتيح البهجة تتجلى في نهاية الرواية وتنفجر وتتخذ المقاومة الحلّ نحو العودة.
ينتقل الأديب حمش في روايته ما بين الأماكن والأسماء، ليبين التغييرات التي أحدثتها الحرب، فينتقل بين مجدل عسقلان والمخيم، ما بين الوطن واللجوء، ما بين المفردات الجديدة التي حلّت على أثر تغيير المكان مثل وكالة الغوث، الخيمة، صفيح النوافذ، الأونروا، الطابو.
أشار الأديب حمش إلى الخيبة من حالة الكذب والخذلان الذي رسمها النظام العربي عبر إذاعة صوت العرب في أثناء الحرب." لم يكمل، فقد رشقته ساق أبي فسكت.
أمي التي كان يفزعها كسر طبق، قامت واجمة؛ التقطت الجهاز،وقالت:خذه إلى المزبلة.
وكذلك معلم اللغة العربية يعبر عن غضبه" كذب..كل شيء كان كذبا
وصرخ: كذب كذب"
نجد حالة الصمت عند أم الطفل حين يحثها ابنها على الحديث عن النكبة فأحيانا لا تستطيع الحديث فتصمت وتمتنع، فيكمل الطفل ويسترجع تفاصيل الذاكرة، فالأم أيضا في حالة نفسية متعبة، ولذا تلتزم الصمت خاصة عند النكسة والهزيمة،" أمي لم تعد تعترض، أُمي دخلت بئر الصمت"ا لأم تمثل حالة اللاجىء الشاهد على مواجع الحرب من الشهداء والتشرد وحالة الخيبة، فالصمت هو ثرثرة الألم والوجع والاحتراق الداخلي للنفس، هو الصدمة من الهزيمة.
وما بين وجع النكبة والنكسة ووجه الحزن يطلّ وجه الطفولة وبعض المقالب من قبل الطفل وأصدقائه في المدرسة، وعلاقة الحب مع نعيمة التي تحقق للطفل اللذة، ويصلان يافا عبر الخيال،كل ذلك يضيف المتعة للسرد وعدم الملل وكأنها استراحة من سيرة مؤلمة.
تكرر ذكر شجرة الأكاسيا عدّة مرات وفي ذلك إشارة لتعلّق الفلسطيني بأرضه وعلاقته القوية بالزراعة، وأيضا هي جسر الحب بين الطفل ونعيمة." وظلّت شجرة الأكاسيا ملاذي".
أثرت الأغاني التراثية الرّواية حيث عبرت عن حالة المخيم في ظلّ الحرب وحالة الخيبة، استخدم الأديب اللهجة الفلسطينية العامية في الحوار وأيضا الفصحى.
وكتبت نزهة أبو غوش:
في روايته هذه، لخّص الكاتب الفلسطيني عمر حمش مسيرة شعب بأكمله، شعب آبائه وأجداده؛ لخّص حياة الفرح والبهجة والحياة الرّغدة وتكاثف الأسرة والبلدة والوطن ما قبل التّهجير عام 1948؛ ثمّ حياة الألم والحزن والقهر والتّشتّت حتّى حرب حزيران 1967.أمّا المكان، فقد ركّز الكاتب على بلدة المجدل، وعسقلان، خان يونس، يافا، المخيّم، مدينة غزّة.
استخدم الكاتب عدّة تقنيّات؛ من أجل إيصال فكرته الرّوائيّة، أوّلها تقنيّة الاستماع إِلى الرّاوي، الوالدين، أو الأجداد الّذين عاشوا وعاصروا الأحداث بحذافيرها، وخاصّة أحداث ما قبل التهجير، حيث استخدم الراوي، كلمة " طردونا، أو وقت الطّرد" بدل كلمة هجّرونا، أو الهجرة على طول مساحة الرّواية.
استخدم الرّاوي أسلوب الاسترجاع، حيث كان يعود إِلى وصف الأماكن مثل البيوت والسّهول، وأنواع الأشجار، وكذلك الأحداث؛ وذلك من خلال أحلام اليقظة، والسرحان. هنا كان الخيال جامحا وفسيحا، وقد استعان الرّاوي بالملائكة، والمحبوبة، والشّهيد، ومن هم داخل القبور؛ من أجل أن يطوف بحريّة فوق سماء البحر والشّوارع والأبنية الّتي ترسخ بذاكرته، والوطن الّذي يرجو العودة اليه. هنا يمكن القول بأنّ الكاتب استطاع أن يوجّه بوصلته نحو النّاحية النّفسيّة للشخصيّات، من حيث تمكينها من التّعبيرعن نفسيّتها المحرومة من العودة لوطنها الأصليّ - يافا، عسقلان، المجدل - وترك المخيّمات الّتي يعيشون بها قضاء مدينة غزّة، حيث المعاناة والظروف المعيشيّة القاسية جدّا.
الوصف في الرّواية دقيق وغير مبالغ به، حيث يخدم الفكرة في النّصّ بشكل واضح.
لقد أبدع الكاتب في وصف الحقول المتروكة بسنابلها الذّهبيّة المتماوجة والأزهار الفوّاحة، والبحر بأمواجه العميقة، والبلد الّتي تشبه الجنّة؛ اعتمد الرّاوي في وصفه على البيئة الّتي يتواجد بها نحو وصف أشجار الكينا والسدر والأكاسيا والجمّيز والنخيل." أبو غازي كان كسعفة" ص4.
رسم الكاتب لوحته القاتمة، حيث المخيّمات وصف تلال الرّمال في قضاء غزّة، جلسة الرّجال والاستراحة لشرب الشّاي والتسامر والحديث عن البلاد، بين المقابر تحت قمر يوصلهم بالبلاد، وصف رشّ أجسام الطّلاب بمسحوق المبيدات الحشريّة كذلك في البيوت، (الأكواخ) حسب ما ذكرها الكاتب في الرواية؛ كذلك صورة اللاجئين وهم يتراكضون لاستلام الطّعام وسلّات الملابس المستخدمة الّتي توفّرها لهم الأونروا؛ والأهمّ من ذلك أبرز الكاتب صورة مؤلمة للاجئ، الّذي يلمّع كلّ يوم مفاتيح عودته بالرّمل والكاز – مفاتيح البهجة - ويصرّ على الاحتفاظ بها؛ خوف أن يكسر الباب إِذا ما فقدها؛ كذلك تفقّد أوراق الطّابو كلّ حين تأكيدا على حفظ ملكيّتهم حين العودة. دور المراهق بطل الرّواية في المخيّم، شقاوته، تدخين أعقاب السجائر، الهروب لدور السّينما، الحبّ الأوّل، اقتناص علاقات غير شريفة..." كنّا نهارات حالمة، وليالي صمت، يخالطها نباح التّلال" ص5.
صورة الطّالب في مدارس المخيّم هي الأشدّ بؤسا وألما: ضرب الطّالب بالفلكة، وصورة الفقر المدقع، حيث ساندوش الفلفل المغمّس بالملح، واللباس المهترئ؛ وقد انعكست الحياة على الطّلاب فولّدت الانفجار الطّلابي بالمظاهرات ومواجهة المحتلّ دون خوف أو تردّد بتشجيع من معلّم العربيّة.
لقد أبدع الكاتب في وصف مناسبة طهور ابن أحد أبطال الرّواية – الهواري – لقد دقّت الطّبول ورفعت المواويل والأوف، تجمّع كلّ أهل المخيّم يدقّون الأرض بأقدامهم حملتهم الحماسة إِلى الفضاء، حتّى أنّهم أخرجوا مفاتيح عودتهم الملمّعة من جيوب قنابيزهم؛ ليشهروها عاليا ويتمايلوا بها مع أغنياتهم الشّعبيّة، وكأنّ يطلقون كلّ غضبهم وقهرهم في الفضاء:
" سايق عليكو الله تحمّوا هالسّاحة شويّة
ويافا عربيّة وأنا دخيلو الله
يا يافا يا نوّارة، يا زينة القوّارة" ص40-41-
لقد كان الأمل موجودا في قلوبهم، وخاصّة بعد الإعلان عن تأسيس جيش التحرير، الّذي سيعيدهم للبلاد؛ لكنّ خيبة الأمل قد أصابتهم بعد حرب حزيران 1967، حيث تدمّر كلّ شيء.
صوّر الكاتب تلك الخيبة والخذلان برمي الراديو الترانوستر في ( الزبالة)؛ لأنّ من خلاله كان التّرويج والبعبعة الكاذبة من إذاعة صوت العرب: " إِنّ طائرات العدوّ تتساقط كالذباب"
صورة المخذولين وسط البحر يتعلّقون بقوارب الصيّادين، إِنّهم يرحلون من جديد...إِلى أين؟
صوّر الكاتب وصمة الهزيمة بكلمة واحدة، حين كان الضابط ينادي بصوته المجروح لعدة مرّات " يا قيادة" وللأسف لم تجب القيادة، واستشهد بعدها فورا.
هناك مصطلحات خلّفتها الهجرة، وقد استخدمها الكاتب بذكاء: على لسان أمّ الحنتوت، حين تعرّضوا لولدها:
"أقصّ شيبتي، إِذا رجعتوا للبلاد"ص53.
قول الرّجل اللاجئ، عند شعوره بالغضب بالألم والقهر من أصحاب المخيّم: "من يقول الشّعر بعد الآن"
ومن المفارقة، الضّحك وسط الهزيمة؛ ومن الأشدّ بلاء استلام هويّة اسرائيليّة بعد الاحتلال مباشرة.
اختار الكاتب نهاية لروايته: تكاثروا. زوّجوا أبناءكم لتكاثروا.
أرى بأنّ الكاتب قد استجار بهذا الحلّ، كمن يستجير بالرمضاء بالنار.
ومن لبنان كتب عفبف قاووق:
الرواية توثّق ما جرى من أحداث ومعاناة داخل فلسطين ومخيمات اللجوء، بدءاً من زمن النكبة وبداية الإحتلال والتهجير، وصولا الى زمن نكسة العام 1967، فأتت على شكل بقايا صور عالقة في الذاكرة، أوردها الكاتب على لسان عدّة رواة بدءا من الجدّ والجدّة مرورا بالأب والأم وإنتهاء بما عايشه الراوي الشاب، والمُلفت في هذه الرواية أنّ الكاتب تَفَلتَ من ذكر الأسماء لهؤلاء الرواة، وكأنه بذلك يقول أن ما ورد على ألسنتهم هو لسان حال كلّ فلسطينيّ وفلسطينيّة عايش تلك المرحلة، فالمعاناة واحدة، وقد طالت شظاياها كلّ نسيج المجتمع الفلسطينيّ آنذاك..
"مفاتيح البهجة" وإن كانت تشير إلى الواقع الفلسطيني إبّان النكبة وما تلاها، إلّا أنّ ما يُسجّل للكاتب، أنّه بالرغم من تلك المآسي والعذابات التي وقعت على الشعب الفلسطيني، فقد جاءت كتابته لها بأسلوبٍ ولغةٍ رصينةٍ هادئةٍ وهادفة في آنٍ معاً،ّ بحيث تستفزّ القارىء وتحثّه على الإيمان بالأمل وبغدٍ أفضل، وتدعو الى ضرورة التمسّك بحقّ العودة مهما طال الزمن ومهما أُسيء التعامل مع تداعيات الأزمة. فقد تضمّنت فيما تضمّنت ما يشبه القراءة الموضوعيّة وشبه السياسيّة لمُسبِبَات هذهِ النكبّة وما تمّ التعامل مع تداعياتها بما هو دون المرتجى.
من المسلّم به أنّ الأدب هو وليد بيئته أو هكذا يجب أن يكون، فللأدباء والمثقّفين دورٌ مهم وأساسيّ في الإضاءة على قضايا المجتمع، وهذا حال معظم الأدباء الفلسطينين الذين كتبوا عن الحرب والنزوح وآلام اللجوء والشتات،وأيضاً عن الأمل والصمود والوعد بانتصارٍ قادم. وبهذا يكون الأديب محارباً ومناضلاً ثقافيّاً يعمل على نشر الأفكار الإيجابيّة والبنّاءة، وتكون الأعمال الروائيّة والأدبيّة الفلسطينيّة عبارة عن ما يُسمّى "النضال بالأدب"، ورزاية مفاتيح البهجة تندرج ضمن هذا الإطار.
هي ليست مجرّد رواية تضيء على الهَمّ المجتمعيّ المقهور، وألم المعاناة في مخيمات التهجير، بل إنّها روايةٌ تناضل بالكلمة، وتواجه بالأدب. وإن كان القلم والخيال يبدوان أسلحة ضعيفة وهشّة في مواجهة آلات التدمير ووسائل الفتك، إلّا أنّهما حتماً سيكونان الأصلبُ والأقوى، ففي البدء كانت الكلمة والبقاء حتماً سيكون لها.
بإستذكار الماضي الجميل قبل النكبة، تبدأ الرواية لتصف لنا الأمّ مواسم الزرع في مجدل عسقلان، حيث المواسم كانت تُفرح الكبيرَ قبل الصغير، وكيف أن من بين الطقوس والعادات في عسقلان تسمية أسابيع شهر نيسان الأربعة بأسماء ودلالات معينة، فالجمعة الأولى منه تُسمّى التائهة، كونها تمثل بداية الشهر، والثانية النبات، وفيها تكون الأرض قد استكملت زينتها، والثالثة مُخصّصة لزيارة القبور والتّرحُم على الأموات، واستجداء عطف الخالق في شأن مخلوقاته، أما الرابعة والأخيرة فسُمّيت بالحلوات، نسبة لما يجري من ابتهاج، ولما يُصرف فيه على صناعة الحلويّات.
كثيرة هي المحاور والمفاصل التي تطرّق إليها الكاتب، ولو بإشارات مختصرة أو عابرة، فقد تحدّث عن مسألة النزوح واللجوء وعمليّات التهجير، وكيف لم يغِب عن الفلسطينيّ الشعور بالأمل، وأنّه سيعود يوما إلى موطنه، لذا فقد كان حريصاعلى الإحتفاظ بأوراق الطابو ومفاتيح البيوت. وأيضا كان للمجازر والإنتهاكات التي مارسها المحتّل حيّزا لا بأس به، ولكي لا ننسى ما تعرّض له شعب فلسطين من نكبات، يُعيدنا الكاتب إلى وصف بعض ما جرى وما ارتكبَهُ المُحتلّ من مجازر، ففي مجزرة خان يونس مثلا كانوا يدفعون الأبواب ويُسمَع صوت الرصاص، وصراخ من يهوون خلف الجدار لتنجلي هذه المجزرة عن أكوام من الشهداء والجرحى.
هذه النكبة التي تعرّض لها الشعب كان لها تداعياتها المُرّة على ظروف حياته اليوميّة والمعيشيّة اضطرّته للإنتظام في طوابيرَ أمام مكاتب الاونروا طلبا للحصص الغذائيّة وبطاقات التموين، وقد إستفاض الكاتب في توثيق عذابات العيش في مخيّمات اللجوء، والفُتات الذي تقدّمه وكالة الاونروا المعنيّة ببرنامج غوث وتشغيل اللاجئين التابع للامم المتحدة، فتحدّث عن الطوابير التي تنتظر أن يُكال لها الإعاشات، أو أن تُمنح صُرّة من صُرر الملابس المستعملة.
لقد أثبتت الأيّام ماضيا وحاضرا، أنّه عند تفلّت الأوضاع وانعدام الأمن والطمأنينة، عادة ما نجد بروز ظاهرة الإنتهازيّين والمستفيدين، الذين يخفون حقيقة وضاعَتهم خلف قناع الثورة والإدّعاء بمساندة القضية، كما تبرز ظاهرة الخيانة والتعامل مع المحتلّ وإستغلال الظروف، وهذا ما جسّده الهوّاري الذي نعم بظروف معيشيّة أفضل من بقية جيرانه، وما حفلة طهور ولده ومظاهر البذخ والترف، سوى دليل على ذلك، وقد إستطاع هذا الهوّاري أن يُقنع الجميع ويوهمَهم بأنه الفدائيّ المغوار، وما هو بالحقيقة سوى سارق البرتقال الذي يبيعه من خلال شبكة توزيع متمثّلة بكمال الخبّاز والمرأة ربيحة، هذا الهوّاري مع رفقته، كانوا أول الذين ارتموا في الماء وتعلّقوا بحافّة المركب للهرب من المواجهة، وأيضا نجد السلّال المغربيّ الفقير الذي زرعه المحتلّ؛ ليكون عينا له لمراقبة سكان الحيّ، عاش وسطهم، وبعد دخول المحتلّ واقتياد الشباب وإعتقالهم، اختفى ولم يُعرف مكانه، هذه النماذج التي يمثّلها الهوّاري والسلّال وممارساتهم هي التي أدخلت الشكّ قي نفوس الناس وجعلت والدة الحنتوت تُمسك بخصلة بيضاء من مقدّمة شعرها وتهزّها، وتصيح: أقصّ شيبتي إن رجعتوا للبلاد.
غالبا ما نجد أن معظم الكتابات الفلسطينيّة تقارب بشكل أو بآخر ظاهرة العمل الفدائيّ، وفي روايتنا هذه إشارة ولو بشكل عابر إلى بداية العمل الفدائيّ الذي جسّده كلّ من الفدائيّ سرحان الذي أستشهد وهو يقاوم، وأيضا معلّم اللّغة العربيّة الذي أسس لبداية التظاهرات وواجه المُحتلّ واستطاع النجاة من قبضته، ولم يجد الإحتلال وسيلة للإنتقام منه سوى بهدم كوخه وتشريد عائلته، أضف إلى هذا، الإعلان عن تأسيس جيش التحرير وتدريب الأفراد وتوزيعهم إلى كتائب، لكن غياب التنظيم وسوء التواصل بين المجموعات كان ظاهرا للعيان، وهذا ما عبّر عنه الضابط وهو ينادي يا قيادة يا قيادة ولا من مجيب، فألقى بالهاتف أرضا، هذا الضابط الذي إستشهد لاحقا بعد أن نصب وسط الشارع رشاشه، وهو يُقسم ألا يمّروا، ولما جاءت الدبابات ظلّ يُطلق النار حتى اخترقت القذيفة صدره.
ويبقى الأمل والإتّكال على الذات هو الدافع والمُحفّز للبقاء والتشبّث بالحقوق، ووحده والد الراوي الشاب من كان يملك رؤية ثاقبة وواضحة لما يجري، ولم تكن تقنعه الظواهر والبيانات الإعلاميّة الآتية من صوت العرب، حيث كان المذيع يفاخر بأنّ طائرات العدّو تتساقط كالذباب، أخفض صوته ونكّس رأسه وقال انتهينا، وأكملَ عندما هجّرونا كانت ذات اللّغة، لتلتقط زوجته جهاز الراديو متوجهةً إلى ابنها قائلة: خذه إلى مُجَمّع الزبالة.
أمام هذا التخاذل الذي ظهر في عدم النصرة الحقيقيّة للفلسطينيّ، يبقى الأمل معقودا على هذا الشعب نفسه، فما حكّ جلدك مثل ضفرك، ولذا فإنّ والد الراوي يدعو للاعتماد على النفس وعدم انتظار المعونة من أحد، يقول:" لا تنتظروا أحدا خارج حدودنا .. تناسلوا فقط .. املؤوها من البحر إلى النهر .. زوّجوا بناتكم بصبيانكم ،وسلّموهم الطابو والمفاتيح، إلى يوم يقضي فيه الله بيننا".
لم يغفل الكاتب عن ذكر بعض مشاهد الحرب، وكيف أن كلّ طائرات مصر قد دُمّرت وهي على مدارجها، ووصل جيش الإحتلال إلى قناة السويس. أمّا في الأراضي الفلسطينيّة فقد جاءت الطائرات وألقت براميلها وقتلت الكثيرين، حتى أنّهم استهدفوا الجنازات فوق القبور، وتشتّت عسكر مصر بعد محاصرته في الفالوجة؛ فسارعتْ الناسُ للهرب وكلّ ما أخذوه شهادات الطابو، ومفاتيح بيوتهم، والتحقوا بالعسكر الهاربة غرباً، ومن على تلال الشاطئ، كان الكبار يحملون الصغار والعجائز، ويتوجهون جنوباّ إلى غزّة.
وينتقل الكاتب بعد ذلك لوصف ممارسات الاحتلال وكيف أنّ من بقي من السكان، إرتضوا بالعيش داخل السياج، وقبلوا أن يكونوا عمال قطافٍ في بساتينهم المصادرة، ناهيك عن عمليّات الدهم والإعتقال، فكان المحتلّ يتوجّه بالنداء لأهالي المخيّم : على الرجال من سنّ 14 إلى سنّ 60 الخروج إلى ساحة بركة المجاري، أو " يا أهالي مخيّم جباليا إنذار، إنذار .. الجيش يُفتّش بيوتكم، وسيقتل كلّ من تخلّف فيه".
كذلك وفي سبيل محاولة طمس الهويّة الفلسطينيّة، يورد الكاتب كيف أنّ المحتلّ يأمر كل من تجاوز عمره الستّة عشر، بالتوجّه إلى مبنى الجوازات في غزّة؛ ليغيّر بطاقته، بأخرى جديدة، تتوسّطها نجمة داوود.
ختاما، مفاتيح البهجة رواية جديرة بالقراءة، وإن كانت قد وصفت الواقع كما هو، إلّا أنّ الكاتب ترك للقارىء مهمّة وضع النهاية المرتجاة والتي تتناسب وحجم القضيّة وقدسيّتها.
وقالت رفيقة عثمان:
سرد الكاتب روايته على غرار التّغريبة الفلسطينيّة، واصفًا المأساة الّتي عانى منها الفلسطينيّون في حقبة زمنيّة ابتداءً من النّكبة عام 1948، والتّهجير القسري للفلسطينيين المُهجّرين من مجدل عسقلان؛ إلى المحيّمات الفلسطينيّة مثل: خان يونس، وجباليا في قطاع غزّة؛ كذلك فترة 1970؛ ولغاية استلام الهويّات الزّرقاء، المدغومة بنجمة داوود الحمراء.
تطرّق الكاتب بسرده حول الحياة الاجتماعيّة والسّياسيّة للّاجئين الفلسطينيين، أثناء حرب النّكسة، وفي أعقابها؛ وسرد اشكال المقاومة والمحاولات للتّصدّي للقوّات المُحتلّة؛ ومن الممكن أن يكون رأي الكاتب وتوجيه التفكير حول وجه المقاومة، وطرق الانتصار والخسارة.
تنحى الرّواية منحى الجنس الأدبي الواقعي والتّأريخي؛ مستخدما لغة عربيّة فصيحة، بليغة ومكثّفة، بعيدة عن الاستطراد فقلّت الصّفحات؛ لاعتماده على الرّمزية في التّعبير والسّرد.
هذا السّرد الرّمزي المُكثّف، حضر لصالح الرّواية، وإن دلّ على شيء فهو دليل على مهارة الكاتب؛ بتوصيل فكره في صفحات محدودة ؛ لكنّها تحمل المعاني والرّموئ العديدة.
من المُلفت للإنتباه، هو استخدام الكاتب حمش للأسلوب المُضحك المُبكي " الكوميديا السّاخرة" أو "الإيروني"؛ عكست الفكر النّاقد للكاتب في سرده لأحداث الحرب والمآسي؛ كما ورد صفحة 91 " وصلت خصّة، فوجدت الحمار عاد، وبال، وبوله سبح إلى جهاز الترانزيستور الّذي انكفأ. جملة أخرى صفحة 53 " أقص شيبتي إن رجعتوا للبلاد" بالإضافة للتعبير الهزلي حول صوت العرب عندما كان يعلن الأخبار أثناء حرب النكسة عام 1967
"طائرات العدو تتساقط كالذّباب" صفحة 86. نهج الكاتب هذا أسلوب بالعديد من الأفكار والأحداث.
لا شكّ بأنّ استخدام الأسلوب (المُضحك المُبكي) ساهم في عرض النقد السّياسي والاجتماعي اللّاذع؛ لإدخال البهجة في قلوب القرّاء، ممّا أضفى تشويقا ومتعة؛ لقراءة نصوص السّرد بطريقة متواصلة حتّى نهاية الرّواية.
ربّما قصد الكاتب بهذا الأسلوب النّاقد، بما احتواه العنوان، والّذي اختاره لروايته، "مفاتيح البهجة". كدعوة للنّهضة والتّوعيّة نحو حق العودة، ومعرفة الحقوق لكل مواطن فلسطيني.
ربّما أيضا هذه النصيحة الّتي وردت في الرّواية " إسمع لا تنظر أحدا خارج حدودنا، تناسلوا فقط. ملقاها من البحر إلى النّهر. زوّجوا بناتكم بصبيانكم، وسلّموهم الطّابور والمفاتيح إلى يوم يقضي فيه الله بيننا". من هنا أيضًا عنوان الرّواية "مفاتيح البهجة" ينبع الأمل بالبهجة والفرح، من تلك المفاتيح المعلّقة على صدور المُهجّرين لأبواب بيوته المهجورة، هي رمز للأمل والفرح بالعودة؛ للأجيال القادمة، عليها استلام المسؤوليّة نحو هذا الهدف السّامي.
نظرة الكاتب عمر حمّش تبعث الأمل والبهجة في النّفوس، على الرّغم من الألم والمعاناة، وقسوة التّهجير في الشّتات، ومحاولات طمس القضيّة الفلسطينيّة؛ وتجاهل حق العودة للّاجئين الفلسطينيين.
سرد الكاتب روايته بضمير "الأنا"، ممّا أضفى مصداقيّة للأحداث، وتُدخل القارئ في حالة تقمّص وتعاطف مع كل المواقف؛ المُعبّرة، ولها بالغ التأثير على العاطفة.
طعّم الكاتب روايته باقتباس بعض الأغاني الشّعبيّة، للزّجال الشّعبي الفلسطيي "يوسف الحسّون"؛ كذلك والأهازيج الفلسطينيّ؛ للتّراث الفلسطينية من أصوات النّساء.
هذه الأغاني توثّق الحضارة الفلسطينيّة على مرّ العصور، ممّا أضافت تشويقًا لأحداث الرّواية. كما ورد صفحة 39 "مين قالوا مضى على فلسطين وراحت عليها". كذلك "معدومين وحقوقنا كلها بترجع معاها". كذلك صفحة 91 "سايق عليكو الله تحمّوها السّحجة شويّة... ويافا عربيّة، وانا دخيلو الله... يا يافا يا نوّوارة يا زينة القوّارة".
خلاصة القول: رواية مفاتيح البهجة رواية جميلة، ويصلح تمثيلها سينمائيّا، رواية تستحق التّرجمة للغات أجنبيّة مختلفة؛ واقتانئها بالمكتبات لعربيّة والفلسطينيّة خاصّة.